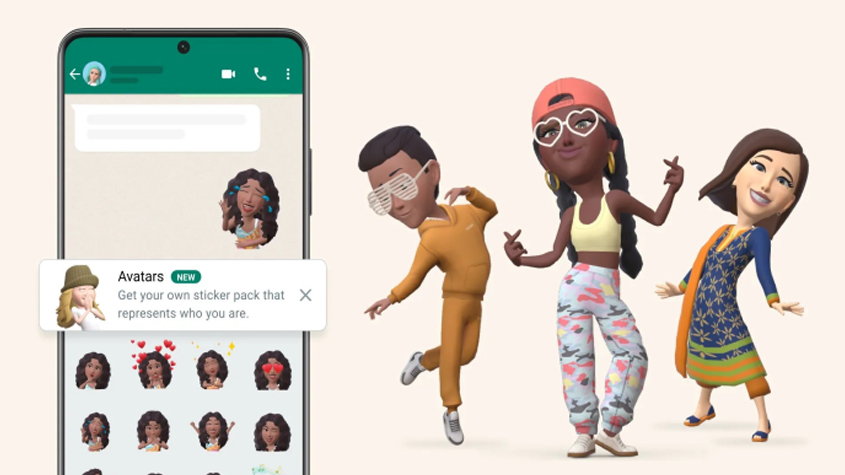تركيا والخيارات الصعبة.. في الحاضر والمستقبل

زياد حافظ
قد تكون القمّة الثلاثية في سوتشي التي جمعت كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيّب أردوغان نقطة فارقة ليس فقط في تاريخ المنطقة ولكن أيضا بالنسبة لتركيا وخياراتها الحاضرة والمستقبلية. فالعلاقات بين هذه الدول مرّت عبر التاريخ القديم والقريب بتقلّبات كانت تعكس موازين قوّة متنافسة بينما ما نشهده في هذا اللقاء تحوّلا في مسار هذه الموازين باتجاه التكامل وليس باتجاه التنافس. فبات واضحا أن العالم تغيّر حيث لم تعد هناك مراكز قوّة أحادية تستطيع فرض إرادتها على العالم دون منازع. القوّة أصبحت منتشرة ومتناثرة في العالم وداخل الدول التي كانت “قوّة” بحدّ ذاتها. وبالتالي لم يعد من الممكن إتباع سياسة “فرّق تسد” التي اتبعها الغرب منذ حقبته الاستعمارية بدءا مع البريطانيين وصولا اليوم إلى الولايات المتحدة. سياسة الضمّ والتجمّع حلّت مكان سياسة الإقصاء والتفرقة.
على قاعدة هذا التحوّل كان لا بد أن تتأثر به تركيا. فأحلام الهيمنة الإقليمية عبر إحياء “العثمانية الجديدة” وصلت إلى طريق مسدود تركيّا بسبب صمود سورية وبسبب عدم وجود بيئة إقليمية وعربية مؤيّدة لذلك. فبعد التنظير لسياسة “صفر مشاكل” مع دول الجوار لصاحبها وزير الخارجية التركي السابق أحمد داوود أغلو أدّت السياسة المتبعة عند القيادة التركية إلى “صفر حلول” مع دول الجوار. ليس هدفنا استعراض ما حصل بمقدار ما يهمّنا استشراف ما يمكن أن يحصل ونتائج الخيارات التي يمكن أن تتخذها القيادات التركية.
فقمة سوتشي قد تكون تتويجا لمسار تركي بدأ منذ فترة وخضع لتقلّبات كبيرة خلال السنوات الست الماضية، وذلك بسبب موقف تركيا في سورية وتهديد مصالح كل من روسيا وإيران فيها. من جهة أخرى واكب هذه التقلّبات تدهور مستمرّ في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة لأسباب مختلفة منها بعض نواحي الموقف التركي في سورية (الولايات المتحدة في قضية أكراد سورية)، ومنها بسبب موجة النازحين واللاجئين إلى أوروبا عبر البوّابة التركية ناهيك عن يقين الموقف الرافض الأوروبي لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. وبناء على هذا العرض المقتضب لمسار علاقات تركيا مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يكون السؤال: ماذا بعد لتركيا؟ فتركيا مقدمة على اتخاذ خيارات صعبة. لم تحسم عند كتابة هذه السطور تلك الخيارات إلاّ أنه بإمكاننا عرض بعض الوقائع وتطوّراتها المستقبلية.
فالخيارات الصعبة تتمثّل في رأينا في مراجعة العلاقة مع كل من الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي والولايات المتحدة. كما أنها تتمثل بتوجّه جديد نحو نسج علاقات لها الطابع الاستراتيجي قد تصل إلى تحالف استراتيجي مع روسيا والجمهورية الإسلامية في إيران. فتركيا قد تكون إحدى البوّابات الغربية للكتلة الأوراسية الصاعدة وللحزام الواحد والطريق الواحد (حو طو) ولمنظومة شنغهاي الأمنية والاقتصادية، ومن يدري المدخل لمجموعة البريكس. وأخيرا يكمن الخيار الصعب الأخير والأهم بالنسبة لنا كعرب، أي مراجعة السياسة الخاطئة تجاه سورية ومراجعة النظرة الدونية تجاه العرب.
فنحن من دعاة تشكيل كتلة جغرافية سياسية اقتصادية مبنية على الموروث التاريخي والحضاري المشترك بين كل من العرب والأتراك والإيرانيين على قاعدة أن العرب عرب، والأتراك أتراك، والإيرانيين إيرانيون. علاقة أساسها التعاون والتكامل وليس التنافس. هذا يعني بالنسبة لتركيا التخلّي نهائيا عن أحلام عثمانية جديدة تهيمن على المنطقة. فالعثمانية القديمة كانت سببا لتفتيت المنطقة عبر الجنوح نحو التتريك القسري للولايات العربية داخل السلطنة العثمانية. أما العثمانية الجديدة فكانت صاحبة المآسي في سورية وسائر دول المشرق العربي عبر توظيف جماعات الغلو والتعصّب والتوحّش لتحقيق تلك المآرب. هنا قد يكون الخيار الأصعب للقيادة التركية أي التخلّي عن سراب العثمانية الجديدة. فهل تستطيع القيادة التركية القيام بذلك؟ في رأينا إن الوقائع الميدانية والوقائع السياسية ستؤدّي إلى تلك المراجعة ولكن ربما ليس في المدى المنظور. بداية المراجعة ستكون من البوّابة السورية. فالتلميح الأخير للرئيس التركية حول إمكانية التفاهم مع الرئيس السوري قد تكون بداية لذلك المسار الصعب ولكن الضروري لضمان وحدة تركيا ومستقبلها في بيئتها الطبيعية التي هي ما نسمّيه بالمشرق.
وهناك خيار آخر صعب قد تواجهه تركيا عاجلا أم آجلا (نأمل عاجلا!) هو العلاقة مع الكيان الصهيوني. لا يغيب عن بالنا أن تركيا كانت أول دولة إسلامية تعترف بالكيان الصهيوني فور إعلان دولته المغتصبة وغير الشرعية. ولكن لا بد من تذكير أن شعبية الرئيس التركي اردوغان مبنية على دغدغة الشعور القومي التركي كما أنها مبنية على تمسّكه بالموروث الديني والحضاري. ذلك الموروث لا ينسجم مع العلاقة مع الكيان. نذكر أنه عندما كان عمدة مدينة استنبول استقبلت المدينة أول مؤتمر من أجل القدس. التجاوب الشعبي والإعلامي التركي حسم تردّد العمدة. فكانت سلسلة من المواقف الاستعراضية ضد الكيان (الانسحاب من دافوس بوجود شمعون بيريز وتدهور العلاقات بعدما تعرّضت له باخرة مرمرة التركية المشاركة في اسطول الحرّية لكسر الحصار على غزّة). طبعا، تراجع أردوغان عن تلك المواقف الظرفية ولكن مجرّد أنه أقدم عليها فإن ذلك يعني أن وفقا لظروف موضوعية مختلفة كالخروج من الأطلسي أو طيّ الصفحة مع الاتحاد الأوروبي أو الانخراط بالكتلة الأوراسية، فإن العلاقة مع الكيان الصهيوني قد تخضع لمراجعة لا تقلّ أهمية وصعوبة عن الخيارات الأخرى.
لكن كيف نقارب تلك الخيارات الصعبة؟ في البداية هناك إشكالية تركيا وعلاقاتها مع الغرب بشكل عام وبشكل خاص مع الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي. هذه الإشكالية تعكس الصراع الفكري والعقائدي بين ورثة مؤسسي تركيا الحديثة أي بعد الحرب العالمية الأولى والتوجّه الصريح نحو التغريب والعمل على الالتحاق بأوروبا. في الحقيقة لم يكن ذلك التوجّه حكرا على مؤسسي الدولة التركية الحديثة فيجب أن نقرّ بأن العديد من النخب العربية وقبل انهيار السلطنة العثمانية نادوا بالتوجّه نحو الغرب وخاصة أوروبا وما زال العديد منهم اليوم ينادون الالتحاق بالغرب وخاصة بالولايات المتحدة. فثقافة الهزيمة موجودة ومترسّخة كما أوضح معالمها العلاّمة ابن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي. لكن توجّه نخب تركيا إلى الغرب اقترن بعمل دؤوب على طمس الموروث التاريخي لتركيا ما خلق تناقضا بين النخب وعامة المكوّنات المجتمعية لتركيا. كما أن “علمانية” تركيا لم تحسم الميل الطبيعي لفئات وازنة من المجتمع التركي للتمسّك بالإسلام وحضارته وتقاليده. فمع صعود حزب العدالة والتنمية كانت بوادر التصالح من قبل نخب حاكمة مع الموروث السياسي والثقافي ممكنة. وللمزيد عن ذلك نشير إلى دراسات الدكتور فؤاد نهرا ومحمد نور الدين.
فالتصالح إذا جاز الكلام مع الإسلام رافقه تشجيع أولي من قبل أوروبا والولايات المتحدة التي وجدت فيما سمّته بالإسلام التركي نموذجا يمكن تعميمه على الوطن العربي وعلى سائر الدول الإسلامية. فمظهر ذلك النموذج يمزج بين التراث والتقاليد ومعالم الحداثة الغربية. لكن في آخر المطاف لم تكن أوروبا مستعدّة لقبول تركيا بينها بسبب أنها كتلة بشرية مسلمة كبيرة (ما يقارب تسعين مليون) قد تدخل إلى الاتحاد الأوروبي وتهدّد الطابع المسيحي له، وهذا ما صرّح به الرئيس الفرنسي السابق فاليري جسكار ديستان. الصدمة كانت كبيرة عند معظم الأتراك، عند المتغرّبين كما عند غير المتغرّبين. فكأن استثمارا تركيا في التماهي مع أوروبا طال تسعة عقود تقريبا لم يف بالغرض لدخول الاتحاد الأوروبي. وكان لذلك الاستثمار نتائج مادية كبيرة كحجم التجارة مع عدد من دول الأوروبية. فالمستورد الأكبر للصادرات التركية كانت (وما زالت) ألمانيا بحوالي 14 مليار دولار عام 2016 تليها المملكة المتحدة بحوالي 12 مليار دولار. أما الولايات المتحدة فلم يتجاوز استيرادها من تركيا أكثر من 6،7 مليار دولار أقل من صادرات تركيا للعراق أي 7،6 مليار. فالسوق العراقي أهم من السوق الأميركي وقد يؤثّر في حسم الخيارات فيما بعد!
فعلى ما يبدو غضّت القيادات التركية النظر عن متابعة ملفّ عضويتها في الاتحاد الأوروبي، على الأقل في هذه الفترة وفقا للمعلومات المتداولة. لم تتخلّ عنها بالكامل وتحتفظ بها كورقة للمستقبل. هذا وقد هدّد الرئيس التركي في شهر أيار/مايو 2017 بسحب ملّف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ما لم يفتح الأخير فصولا جديدة في العلاقة. وهذا قد يشكّل أوّل الخيارات الصعبة التي قد تتخذها تركيا. كل ما يعرضه الآن الاتحاد هو علاقة تفضيلية أستراتيجية بديلا عن الانضمام الكلّي وهذا ما لا ينسجم مع الأهداف التركية المعلنة.
أما على صعيد العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا فالتدهور مستمر بينهما رغم العلاقات التاريخية التي تربطهما منذ العقود الأخيرة للسلطنة العثمانية، ورغم حجم الجالية التركية المقيمة في ألمانيا. فهذه الجالية حاول الرئيس التركي تعبئتها في حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة. غير أن اعتراض المستشارة الألمانية على السماح لوزراء أتراك بزيارة الجاليات التركية لأغراض انتخابية ساهمت في توتير العلاقات بين البلدين ما جعل الحذر والشكوك بينهما يسيطر على مستقبل تلك العلاقات. أضف إلى ذلك تهديد الرئيس التركي ألمانيا وسائر دول الاتحاد بإرسال موجات جديدة من النازحين واللاجئين زادت من الحذر المتبادل.
بالمقابل قامت الدبلوماسية الروسية بتنفيذ سياسة احتوائية لتركيا ضمّت عدّة أهداف، سياسية، وعسكرية، واقتصادية. في البداية اعتمدت روسيا على الإغراء الاقتصادي. فتمتين العلاقات الاقتصادية، هو قرار سياسي بامتياز وليس بالضرورة مبنيا على المنفعة المادية المباشرة أو حتى الطويلة المدى، فإن ذلك القرار يمهّد لعلاقات سياسية أكثر انسجاما مع المناخات التي توجدها الاتفاقات الاقتصادية. فرغم التقلّبات بالمواقف التركية بسبب الحرب في وعلى سورية والتي أدّت إلى مواجهة عسكرية بين روسيا وتركيا (إسقاط طائرة روسية فوق الحدود السورية التركية) اعتمدت روسيا سياسة الصبر بل زادت من الإغراءات الاقتصادية. فحجم المبادلات التركية الروسية كانت قد تراجعت بنسبة 43 بالمائة في بضعة أشهر عام 2016 إلى 6،3 مليار دولار بينما كانت حوالي 13،7 مليار دولار في العام السابق. لكن بعد محاولة الانقلاب الفاشل الذي أعدّته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والتي كشفتها أجهزة الاستخبارات الروسية منقذة بذلك الرئيس التركي فإن الهدف المرجو من الاتفاقات الاقتصادية المعقودة بعد لقاء الرئيسين بوتين وأردوغان هو الوصول إلى ما يقارب 100 مليار دولار أي تقريبا ثلث حجم التجارة الإجمالية الحالية في تركيا. وكذلك الأمر بالنسبة لقيمة الاتفاقات مع الجمهورية الإسلامية في إيران، أي 100 مليار دولار. فتصبح الدولتان تشكّلان تقريبا ثلثي التجارة الخارجية التركية حاليا بينما الغرب يتكلّم عن عقوبات على تركيا وليس على زيادة التبادل. إذا لم يكن ذلك تحوّلا استراتيجيا فما هو إذن مضمون التحوّل الاستراتيجي؟
وفيما يتعلّق بالبعد العسكري للعلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا فإن بيع منظومة الصواريخ الروسية المتطوّرة جدّا أس 400 لتركيا أقلقت الحلف الأطلسي. فهذه المنظومة تعني تدريب الكوادر عليها وبالتالي نسج علاقات متينة مع الضباط الأتراك. من جهة أخرى استطاعت روسيا أن تؤمّن مرور سفنها في المضائق التركية من البحر الأسود إلى البحر المتوسط دون التعرّض لها بتحريض أميركي أو أوروبي. كما أن الاتفاق الروسي التركي جعل من البحر الأسود بحرا مشتركا خارج النفوذ الغربي أو الأميركي رغم وجود بضع قطع حربية للأخير. هذا دليل واضح على بعد نظر القيادة الروسية التي استطاعت أن تتجاوز تداعيات إسقاط تركيا لإحدى طائراتها فوق الحدود السورية التركية.
أما على صعيد العلاقات مع الحلف الأطلسي فالمعلومات الوافدة تشير إلى تزايد تململ القيادات التركية من أداء قيادة الحلف الأطلسي. فالمناورات العسكرية الأخيرة للحلف وضعت تركيا ورئيسها في خانة “العدو” ما أغضب تركيا وأدّى إلى انسحابها من المناورات. لم تكن الاعتذارات الصادرة عن أمين عام الحلف الأطلسي كافية أو مقنعة لاسترضاء الحكومة التركية. ف “الخطأ” الذي وقع هو من صنع مقاول مقرّب من معارض الرئيس التركي فتح الله غولن، إي عذر أقبح من ذنب! في مطلق الأحوال هناك أصوات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تنادي بإعادة النظر في جدوى الاستمرار بالحلف الأطلسي. مما لا شكّ فيه أن الرأي العام التركي قد يتقبّل الخروج من الحلف وفقا لدراسة نشرها مركز أبحاث تركي “استنبول ايكونومي اراشتيرما” في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 حيث ما يوازي 67 بالمائة من المستطلعين يعتبرون أن أمن تركيا يمكن تحقيقه دون الاستمرار في الحلف. ما ساهم في فتور العلاقة بين الأطلسي وتركيا شراء الأخيرة منظمة صواريخ أس 400 الروسية. فكسر أحادية مصادر التسليح من خارج الأطلسي خطّ أحمر له تداعيات. لا نستطيع أن نجزم بأن تركيا ستخرج من الأطلسي لكن إرهاصات الخروج باتت واضحة. فالأشهر القادمة قد توضح الصورة. فخروج تركيا من الحلف قد يشكّل ضربة قاسية له خاصة وأن تركيا تملك أكبر قوّة عسكرية في الحلف بعد الولايات المتحدة. فهل سيسمح الأطلسي بذلك؟ فخروج تركيا من الأطلسي قد يكون خيارا صعبا للغاية قد يؤدّي إلى ردّة فعل أميركية قاسية.
ومن ضمن أسباب الفتور أو تدهور العلاقات بين تركيا والأطلسي بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص رفض الأخيرة تسليم فتح الله غولن المطلوب من المحاكم التركية. أما السبب الثاني فهو الخط الأحمر التركي في موضوع أكراد سورية. على ما يبدو فإن الرئيس ترامب حسم الخيار لصالح تركيا، أي إيقاف تسليح أكراد سورية، للحفاظ على العلاقة معها. غير أن الدولة العميقة ما زالت تراهن على القوّات السورية الديمقراطية (قسد) التي يشكّل الأكراد في سورية عمودها الفقري، وذلك كورقة تفاوض في الملّف السوري في الحد الأدنى وكأداة لاستمرار النزيف في سورية كحدّ أقصى، أو كتبرير لوجود القواعد العسكرية الأميركية غير الشرعية على الحدود الشرقية السورية العراقية. ليس من المؤكّد إذا سيتمسّك الرئيس الأميركي بقراره أو يتراجع عنه تحت ضغط مراكز القوة داخل الدولة العميقة وحتى في إدارته. ففي آخر المطاف لا يكترث الرئيس الأميركي لتركيا أو للأكراد. لكن بات واضحا أن العلاقات التركية الأميركية لم تعد كما كانت منذ سنوات وخاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. فالعلاقة مع الولايات المتحدة ومراجعتها قد تكون الخيار الثالث الصعب.
أما فيما يتعلّق بالعلاقة مع الجمهورية الإسلامية في إيران فلا بد أن نتذكّر إلى التنافس التاريخي بين السلطنة العثمانية والدولة الصفوية. لكن في القرن الحادي والعشرين يبدو أن المنافسة قد تستمر ولكن ضمن سقف سياسي استراتيجي هو الجنوح نحو الانضمام الدولتين إلى الكتلة الأوراسية ومشروع طو حو (طريق واحد حزام واحد) الذي يربط بحر الصين بالبحر المتوسط. كما لا بد من التأكيد أن التقارب التركي الإيراني ينسف سردية الصراع السنّي الشيعي التي حاولت ترويجه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ومعهما بعد دول مجلس التعاون الخليجي. فالتفاهم التركي الذي قد يتحوّل فيما بعد إلى علاقة استراتيجية قد يساهم بشكل أساسي في استقرار المنطقة أمام تحرّكات الحلف الأميركي الصهيوني وبعض أتباعه من العرب.
فيما يتعلّق بالعلاقة مع العرب فالخيارات الصعبة ستكون نتيجة لمراجعات عميقة. لسنا متأكدّين أن القيادة التركية الخالية قد تتخلّى عمّا تُسمّيه بالعثمانية الجديدة. موقفنا أوضحناه في الفقرة الخامسة من هذا المقال أي التكامل وليس التنافس بين العرب والأتراك. فلا استقرار بدون توازن ولا توازن بدون احترام مشاعر العرب ولغتهم وثقافتهم. فعدم فهم هذه الحقيقة أدّى إلى كارثة تفكيك السلطنة العثمانية والغرق في قرن من عدم الاستقرار. أما اليوم العودة إلى العثمانية، جديدة أو قديمة، لن يستقيم مع الشعور القومي العميق لدى جماهير العرب. ومدخل التغيير يكون في مراجعة القيادة التركية لسلوكها في سورية. فهل تستطيع القيادة التركية استيعاب تلك الحقيقة وعدم الاستمرار في حالة الإنكار؟
فهذه التوجّهات نحو الشرق والمحيط العربي والإسلامي محفوفة بالمخاطر. المخاطر داخلية أولا. فهل يستطيع أردوغان أن ينتفض بشكل كلّي على إرث كمال أتاتورك في تغريب تركيا؟ هناك في الدولة العميقة في تركيا من يعتقد أن العلاقة مع الغرب هي طريق الخلاص. لكن حملات التطهير التي حصلت داخل القوّات المسلّحة وجهاز القضاء والتعليم أسست لترسيخ مفاهيم جديدة. غير أن التنوّع التركي في مكوّناته قد يشكّل عقبة في التوجّه إلى الشرق خاصة وأن فئات وازنة من المجتمع التركي تعتبر أنها مغبونة. فهل تصبح راس حربة لتقسيم تركيا إلى دويلات عرقية أو مذهبية؟
أما على الصعيد الخارجي فمن الصعب أن يستسلم الغرب إلى التوجّهات التي ترسم. حاول الغرب دعم انقلاب لكنه فشل. لكن من يضمن أنه لن يجرؤ مرّة ثانية وثالثة طالما الوضع الداخلي غير محصّن؟ وتحصين الوضع الداخلي لن يتّم عبر المزيد من القمع والإقصاء بل عبر الانفتاح والمشاركة الفعلية لمكوّنات المجتمع التركي. فهل يستطيع أو بل هل يريد ذلك الرئيس التركي رجب أردوغان؟ هذه مجمل الأسئلة والخيارات الممكنة التي تواجه تركيا في المستقبل القريب.
صحيفة رأي اليوم
أضيف بتاريخ :2017/11/30