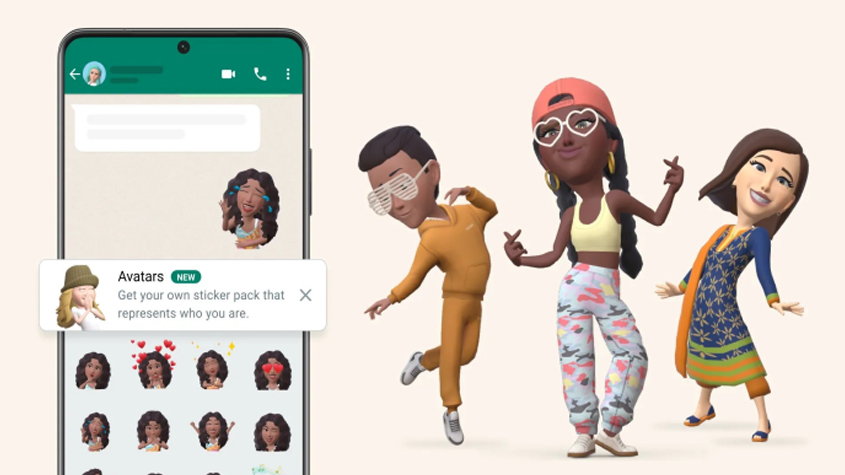من المسؤول عن تفشي الجرائم في أمريكا؟

د. هشام أحمد فرارجة
تأتي كتابة هذه المقالة على خلفية قيام شخص أمريكي باقتحام مكاتب أحدى الصحف الأمريكية اليومية التي تصدر في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند، كابيتال غازيت، وإطلاقه النار باحتراف على مجموعة من الصحفيين والعاملين في الصحيفة، الأمر الذي نتج عنه مصرع خمسة منهم وجرح اثنين آخرين. كان هذا قد حدث في الثامن والعشرين من حزيران المنصرم من هذا العام عندما قام جارود راموس بارتكاب جريمته تلك بحق هذه الصحيفة والعاملين فيها. راموس يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما ويحمل شهادة في علوم الحاسوب. كان قد عمل من قبل في المركز الأمريكي للإحصاء والعمال.
والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا أقدم هذا المجرم على ارتكاب جريمته؟ ليس هذا جديدا في المجتمع الأمريكي، حيث هي واحدة من الجرائم المتكررة باستمرار.
تكتسب هذه الجريمة أهمية خاصة، كونها ارتكبت بحق صحفيين، حيث هي أكبر اعتداء من هذا النوع في التاريخ الأمريكي المعاصر. لم تلقَ هذه الجريمة الاهتمام المتوقع في الإعلام الأمريكي إزاء جريمة بهذا الحجم، وبهذه الفداحة. عادة، فان الإعلام الأمريكي يقيم الدنيا ولا يقعدها لفترة طويلة من الزمن، قد تتجاوز أسبوعين، عندما يكون القاتل من أصول عربية أو مسلما أو أسودا.
فهناك عنصرية وتمييز واضح على أسس عرقية ودينية واثنية. راموس ليس عربيا، ولا مسلما، ولا أسودا. بل هو أمريكي أبيض اللون. ورغم وجود عدة مؤشرات على عدائه لهذه الصحيفة وتهديده لها منذ عدة سنوات نتيجة لنشرها مقالة عنه بعد مضايقته لإحدى النساء، إّلا أنه لم يكن تحت المجهر أو متابعا. كما أن أحدا من الإعلاميين لم ينطق بكلمة الإرهاب، ولو للحظة واحدة في توصيف هذه الجريمة النكراء. كما أن أحدا لم يقم بملاحقة أي من أقارب هذا المجرم أو عائلته.
وبالاعتماد على أرقام دقيقة واحصائيات موثقة، فقد ارتفعت نسبة حالات القتل الجماعي في المجتمع الأمريكي في العامين الأخيرين بشكل ملحوظ، وخاصة منذ تسلم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مقاليد الحكم. ورغم أن المجتمع الأمريكي يعاني من كونه يحتل أعلى نسبة جريمة في العالم، إلا أن نسبة هذه الجريمة تبقى آخذة في الارتفاع، رغم كل ما تنتجه من ضحايا في المدارس والجامعات، والمحال التجارية، والأماكن العامة، ودور العبادة والمؤسسات الخاصة، والملاهي. ومن الملفت للانتباه أن العدد الأكبر من هذه الجرائم لا تخضع في تصنيفها للصورة النمطية التي يلجأ إليها الإعلام عادة في تبسيط الأمور، بحيث يحصر مرتكبيها في من هم عرب، أو مسلمون، أو من هم سود، أو من منهم من خلفيات اثنية أخرى. كثير من حالات القتل الجماعي التي تتطلب حرفية ودراية مسبقة يرتكبها مواطنون أمريكيون بيض.
الحالات كثيرة جدا، بحيث يستحيل تعدادها أو تحليلها هنا. ولكن، على سبيل المثال لا الحصر، تبرز خطورة ما قام به أمريكي يبلغ من العمر تسعة عشر عاما، من قتل بدم بارد لسبعة عشر طالبا في المدرسة الثانوية التي كان يدرس فيها، في بلدة باركلاند بولاية فلوريدا، في منتصف شهر شباط من هذا العام. ورغم ارتفاع عدد الضحايا في هذه المجزرة، إلا أنها لم تصنّف كعمل إرهابي، كون مقترفها لم يكن يخضع للصورة النمطية سالفة الذكر.
ومن قبل هذه الحادثة، جرت عملية أكبر قتل جماعي في التاريخ الأمريكي المعاصر في الأول من شهر تشرين الأول الماضي في مدينة لوس فيجاس بولاية نفادا، على يد أمريكي تجاوز عمره الستين عاما، ستيفن بادوك، والذي قتل ثمانية وخمسين شخصا وجرح مئات آخرين، بينما كانوا يحضرون امسية موسيقية. لم يكن بادوك يخضع للمراقبة أو المتابعة المسبقة، رغم حيازته على ترسانة أسلحة هائلة تجاوزت العشرين رشاشا أوتاماتيكيا، تمكن من إدخالها جميعها إلى غرفته في الفندق الذي كان يقيم فيه، وذلك لأنه هو الآخر لم تنطبق عليه الصورة النمطية المعهودة. وذات الشيء، بل أكثر، يمكن أن يقال عن المجزرة التي ارتكبها آدم لانزا، ذو العشرون عاما بحق عشرات الأطفال في مدرسة سانديهوك الابتدائية في مدينة نيوتاون بولاية كاناتيكيت، قبيل أعياد الميلاد، عام 2012. بكل بساطة، تدون الجريمة ضد شخص مختل عقليا قام بقتل آخرين ومن ثم الإقدام على الانتحار. ورغم أن تلك الجريمة قد روّعت المجتمع الأمريكي، إلا أن صناع القرار أخفقوا، بشكل صارخ، في تعديل أي من القوانين التي تتعلق بملكية السلاح وحمله.
يأتي هذا الارتفاع الحاد في نسبة الجريمة بهذا الشكل الملحوظ والمتسارع نتيجة لعوامل عدة، قد يكون من أهمها تدعيم البيئة الحاضنة لذلك على أعلى مستويات صناعة القرار في الولايات المتحدة. فأيضا على سبيل المثال، لا الحصر، كان ترامب أثناء حملته الانتخابية قد أطلق تصريحا مفزعا، والذي ترك الكثير من الأصداء في المجتمع الأمريكي، بما له من دلالات، وبما سيفرزه من انعكاسات. فبينما كان يحاول إثبات قوته الشعبية أثناء لقاءه بمناصريه، قال بأنه يستطيع أن يقف في وسط الشارع رقم خمسة في نيويورك ويطلق النار على شخص ما، دون أن يفقد صوتا واحدا من بين الذين يؤيدونه.
وبالإضافة إلى هذا الجو العام الموجود من قبل، والذي غذاه ترامب بمثل تصريحاته تلك، تقف جمعية البنادق الوطنية على رأس أقوى جماعات المصالح، والتي تتنافس وتتقاطع في قوتها مع جماعات المصالح الإسرائيلية-الأمريكية. هذه الجمعية تتمتع بدرجة عالية من النفوذ بين صناع القرار، بحيث تغدق التبرعات على أولئك المرشحين الذين يدعمون أهدافها وبرامجها، ولا يعارضونها، في كافة المناصب الحكومية، من ناحية، وتتمترس لإفشال أي مرشح يحاول الوقوف في وجه تسويقها لما تبدع في إنتاجه من أدوات القتل. ولذلك، تجد أن غالبية المشرعين يخشون حتى من مجرد توجيه الانتقاد لهذه الجمعية، الأمر الذي يترتب عليه إخفاق أية محاولة لتعديل القوانين التي تجيز الاتجار الحر بالسلاح، دونما قيود حقيقية. فكم كان صاعقا أن تشاهد على أحد البرامج المتلفزة عضوا في إحدى عصابات الجريمة المنظمة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا يقول متبجحا، بأنه أسهل عليه الحصول على بندقية من شراء علبة كولا.
وإذا ما أضيف إلى ذلك اتساع رقعة المساحة التي تحوي مشاهد وأساليب ارتكاب أعمال العنف في البرامج والمسلسلات المتلفزة والإذاعية وألعاب التسلية والكرتون للأطفال، يسهل عندها فهم ماهية ودوافع هذا الاستشراء الكبير لأعمال الجريمة. فعقلية رامبو تسيطر على الكثيرين، خاصة في ظل الانتشار الواسع لتعاطي العقاقير الطبية والمنشطات والمنبهات التي تحدث اختلالات في التوازن النفسية عند من يقبلون عليها. في أجواء كهذه، يجب أن لا يكون مفاجئا أن المجتمع الأمريكي يعاني من وجود أعلى نسبة جريمة في العالم، رغم كل مظاهر قوته وتطوره في مختلف المجالات. وعلى ذلك يترتب كون هذا المجتمع يحوي أعلى نسبة سجناء مدنيين في العالم، وذلك لان التركيز لا ينصب على ضرورة معرفة الأسباب التي تقف وراء هذه الظواهر، وإنما على تبادل المناكفات حول الأعراض الناتجة. فمثلا تجد مناصري وأعضاء جمعية البنادق يدافعون عن مواقفهم متسلحين بما جاء في التعديل الثاني للدستور الأمريكي، والذي يجيز حيازته السلاح وحمله بشكل واسع. وتجدهم أيضا يطرحون أن أسباب ارتفاع نسبة الجريمة لا تتعلق بما تقوم به جمعيتهم من ترويج واسع لكافة أنواع الأسلحة، وإنما للتراجع في الصحة النفسية عند من يرتكبون هذه الجرائم، وأيضا بسبب تراجع وسائل الحماية للمواطنين، سواء في المدارس والجامعات، أو في المحال التجارية التي تتعرض لعمليات القتل الجماعي. وعليه، تجدهم يقترحون أن العلاج يكمن في تسليح المعلمين والأساتذة في المدارس والجامعات، مثلا، لتمكينهم من التصدي لأي طالب أو طالبة تقدم على إطلاق النار.
إلى هذا الحد، وصلت درجة تهافت الجدل حول مسببات القتل الجماعي في المجتمع الأمريكي، وكأن المعلم نفسه أو الأستاذ قد لا يقدم على ارتكاب حماقة ما وقتل من هم أمامه من طلاب، في الوقت الذي توثق فيه حالات اعتداء من قبل أشخاص بكافة الخلفيات، سواء كانوا أطباءً، طيارين، أساتذة، عمالا، أو طلابا.
فمحاولة معالجة خلل مجتمعي عميق ما بتعميق جذور المشكلة، بدلا من استئصال مسبباتها، لا شك ينتج حجما أكبر لذات المشكلة. وللبرهنة على ذلك، يكفي استعراض بعض الاحصايات المتعلقة لعام 2018 الذي لم ينقضِ بعد. فهناك حتى الآن أكثر من 28763 حادثة اعتداء بالسلاح. وقد نتج عن هذه الحوادث 17175 حالة قتل، و113612 إصابة. عدد من قتلوا وجرحوا من الأطفال الذين لم يتجاوزوا الأحد عشر عاما زادت على 1326 حالة، بينما عددهم ممن تراوحت أعمارهم بين اثني عشر وسبعة عشر عاما تجاوز 11366 طفلا. وبشكل خاص، تجاوز عدد حالات إطلاق النار والقتل داخل المدارس 40 حالة، منذ مطلع هذا العام، فقط.
للقارئ أن يقارن مدلولات مثل هذه الأرقام مع ما تردد في الإخبار مؤخرا عن اضطرار هولندا، مثلا، لإغلاق سجونها بسبب عدم وجود مجرمين. يمكن أن تصبح الأرقام مفزعة بشكل أكبر عندما تخضع للتحليل المفصل، من حيث هوية ولون وأعداد من يقومون بعمليات القتل، من ناحية، ومن يصبحون ضحايا القتل، من ناحية أخرى. فالمتتبع لا يسعه إلا وأن يلاحظ الفرز العنصري بين مكونات المجتمع الأمريكي، حتى فيما يتعلق بمستوى وعمق انتشار الجريمة وجغرافيتها، رغم ما تمت بلورته من قوانين للمساواة، تمخضت عن حركة الحقوق المدنية التي قادها الراحل مارتين لوثر كنج جونير. فمثلا، تجد كثيرا من المواقع المكتظة بالأفارقة السود ومعسكرات السكان الأصليين الذين يعرفون بالهنود الحمر تحفل بأدوات القتل وتدمير المجتمعات، كالسلاح والمخدرات، بينما تكاد تنعدم فيها وسائل التطوير والتعليم.
إن المسؤول عن ذلك كله هو نظام كامل متكامل، ببنيته ووظائفه السياسية والاقتصادية والمجتمعية. فالفلسفة الفكرية السائدة تقوم أساسا على مبدأ ضرورة تكثيف الربح المادي. وهذا هو المحرك الرئيس لعمل جمعية البنادق الوطنية، حيث تصبح كافة القيم والمثل الأخرى ثانوية، أن ذكرت أصلا.
والقائمون على إدارة المؤسسات التنفيذية والتشريعية يصبحون أسرى لهذه الثقافة السائدة وإفرازاتها، بحيث لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا إزاء عمليات القتل التي تتكرر يوما بعد يوم. ومن أجل الهاء المجتمع ومخادعته ببعض عوارض هذه الآفة، تلجأ المؤسسات الإعلامية المتنفذة، مدعومة، بل وموجهة من قبل النظام السياسي، لتوجيه أصابع الاتهام نحو الآخر، أي من هو من أصل عربي، أو مسلم، أو أسود، أو ذي خلفية اثنية أخرى، علما بأن الأجهزة المختصة توثق أن النسبة الأعلى من أعمال الجريمة والإرهاب ضمن ما يعرف بالإرهاب المحلي ترتكب من قبل من هم أمريكيون بيض. فكثيرة هي الحوادث التي يقوم فيها أحد أفراد الشرطة البيض بقتل مواطن أسود، دون أن تنصف العدالة المقتول وإسرته. ولا أدل على ذلك من الحادثة الشهيرة التي حدثت في شهر آب عام 2014 في مدينة فرغسون بولاية مزوري، حيث قام أحد أفراد الشرطة بقتل المواطن الأسود مايكل براون، رغم أنه لم يشكل أي خطر أمني على أحد. ورغم أهمية هذه الحادثة، إلا أنها ذاع صيتها بسبب انتشار الأخبار عن حجم الاحتجاجات التي سببتها في فرغسون عند حدوث عملية القتل. لكن مثيلاتها كثيرة، بل وكثيرة جدا، ومعظمها لا تصل تفاصيلها إلى وسائل الإعلام، أصلا. فحادثة أخرى، والتي هزت كثيرا من قطاعات المجتمع الأمريكي، كانت تلك التي حدثت قبل تسعة أعوام، عندما قام أحد أفراد الشرطة بقتل شاب أسود، أوسكار غرانت، في محطة القطارات في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، ليلة رأس السنة الميلادية عام 2009، بينما كان الشاب مستلقيا على الأرض ومستسلما بالكامل. نظام العدالة قام بتبرئة الشرطي القاتل، رغم وجود أدلة دامغة، غير قابلة للطعن على ارتكابه للجريمة.
ضمن هذا السياق، يمكن فهم بعض جوانب البيئة العامة التي تمت فيها عملية قتل الصحفيين في صحيفة كابيتال غازيت مؤخرا، ومن ثم، إدراك طبيعة ردة الفعل الخافتة من قبل الكثير من المؤسسات. ورغم إطلاق ترامب لقب “أعداء الشعب” على الإعلام وتكراره بأنهم الإعلام الكاذب، ورغم ما يمكن أن يوجد من صلة بين تأثيرات تصريحات ترامب المتضمنة لعبارات العنف، من جهة، وارتفاع نسبة الجريمة، بما فيها الحادثة الأخيرة التي ارتكبها راموس، من جهة أخرى، إلا أن ردود الأفعال بشكل عام لا ترتقي إلى مستوى فداحة مثل هذه الجرائم.
وبتهيّؤ الظروف لترامب لكي يختار قاضيا إضافيا محافظا للمحكمة الأمريكية العليا بعد إعلان أحد قضاتها التسعة، آنثوني كندي قراره بالتقاعد، تزداد احتمالات أن يحصن النظام السياسي نفسه بمزيد من وسائل الحماية التي تمكنه من غض الطرف عن تدهور مستويات الأمان الشخصي في المجتمع الأمريكي، ومن ثم، تعزيز قوة ونفوذ شركات تصنيع وبيع الأسلحة.
وعليه، فأن قيام هذه الشركات بالاتجار بالأسلحة، داخليا وفي العالم الخارجي، سوف ترتفع وتيرته وتتسع رقعته، مما سيبقي على الولايات المتحدة كالدولة الأولى في العالم التي تقوم بتصدير الصناعات العسكرية إلى دول وأطراف أخرى عديدة. وهذا يعني أن هذه الشركات العملاقة ذات النفوذ الهائل سوف تعمل كل ما في جهدها على خدمة مصالحها، وذلك باللابقاء على الصراعات الدموية القائمة محتدمة، ولخلق صراعات جديدة، أينما تسمح الفرص لفعل ذلك.
فتجارة السلاح سوف تتعزز وتستمر في كونها إحدى خصائص السياسة الخارجية والمحلية الأمريكية، خدمة لهذه الشركات.
صحيفة رأي اليوم
أضيف بتاريخ :2018/07/03