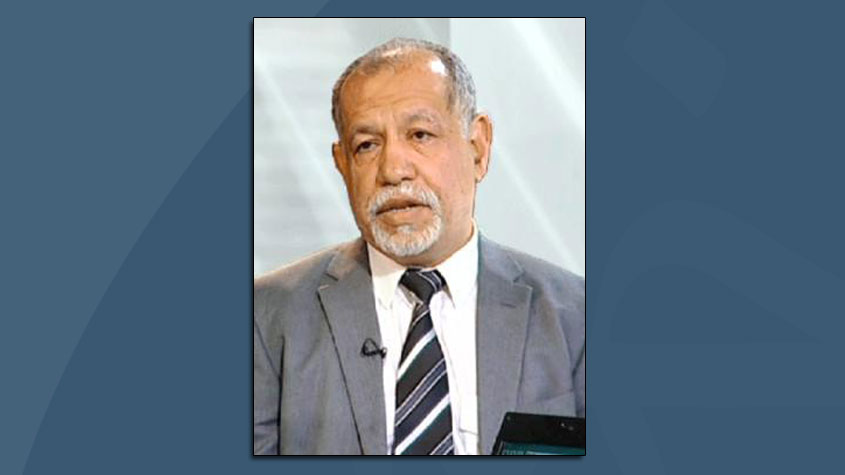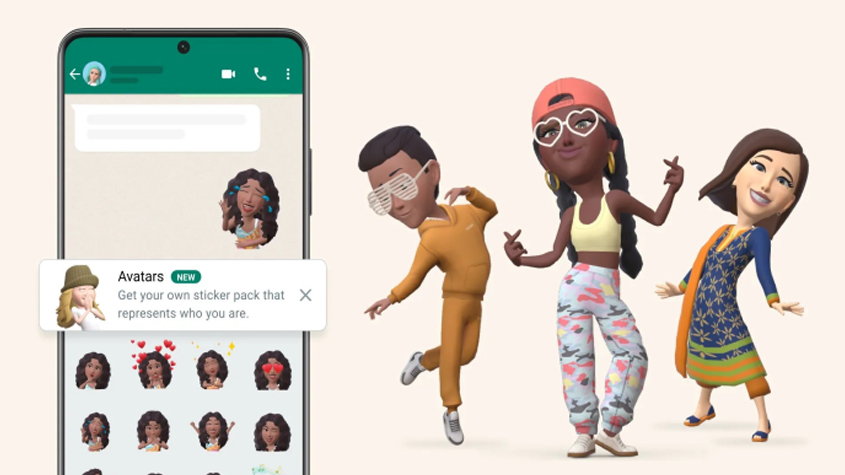الأمة بين حقبتين تفصلهما مائة عام

د. سعيد الشهابي ..
يقتضي المنطق البشري السوي أن تتعلم الأمم من تجاربها لكي تنهض، وأن لا تكرر أخطاء الماضي، وأن تتطلع دائما إلى مستقبل أفضل. هذه بديهيات لا تحتاج لتفسير أو إثبات. ولكن هل الأمر هكذا حقا؟ ولكي يتضح ما إذا كانت أمة العرب قادرة على تفعيل تلك البديهيات يجدر مقارنة أوضاعها في حقبتين يفصلهما قرن كامل. فما بين العام 1917 و 2017 وقعت حوادث وتطورات كثيرة، ايجابية وسلبية، أوصلت أوضاع العرب والمسلمين إلى ما هي عليه الآن. فكيف كان المشهد العام في المنطقة العربية خصوصا الشرق الأوسط قبل مائة عام؟ يومها لم تكن الأمة قد دخلت العصر النفطي بعد، وان كان النفط قد اكتشف في بعض بلدانها التي بدأت تصديره بمعدلات متواضعة. لم يكن هناك تطور مدني واسع في أغلب بلدانها. وكان الاستعمار قد بدأ عهده الأسود الذي استمر أكثر من نصف قرن. أساطيل بريطانيا «العظمى» كانت تمخر البحر حتى منطقة الخليج وتدير شؤون مشيخاتها عن قرب. القوة الاستعمارية الكبرى كانت تتصرف بغطرسة وتكبر، وتتصرف في شؤون المنطقة كما تشاء. كانت في صراع مع الدولة العثمانية التي كانت تعيش حالة من الهرم والضعف البنيوي الذي لم يمهلها طويلا، فما هي إلا بضع سنوات بعد الحرب العالمية الأولى حتى انتهى ذلك الكيان بصورة تشبه إلى حد كبير (مع اختلافات كثيرة) تداعي الاتحاد السوفياتي في 1989. كان الغرب يمثل لقطاعات الأمة المختلفة بعبعا مرعبا ومكروها، فكان هناك تردد حتى في ارتداء الزي الغربي. وبرغم الوجود الاستعماري إلا أن العرب والمسلمين كانوا محصنين ضد التأثير الثقافي المباشر.
في بداية الحقبة (1917) حدث تطوران كبيران تركا آثارهما حتى اليوم وساهما في منع أي تطور سياسي أو اقتصادي حقيقي في المنطقة: أولهما اتفاقية سايكس بيكو وثانيهما إطلاق وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وبذلك تأسست الحقبة التي هي موضع المقارنة في هذه السطور. تمثل سايكس ذروة الغطرسة الاستعمارية وعدوانها على العالم وتعبيرا عن أطماع أصحابها في أراضي الآخرين. كان الاتفاق تفاهمًا سريًا بين فرنسا وبريطانيا بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام منطقة الهلال الخصيب بينهما لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. وتم الوصول إلى هذه الاتفاقية بين تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1915 وأيار/مايو من عام 1916 بمفاوضات سرية بين الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس. وتم الكشف عن الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في روسيا عام 1917، مما أثار الشعوب التي تمسها الاتفاقية وأحرج فرنسا وبريطانيا. وخلال الحرب العالمية الأولى وضعت خطة التحريض ضد الحكم العثماني في ما سمي «مراسلات حسين ـ مكماهون» بين حسين بن علي وهنري مكماهون الممثل الأعلى لبريطانيا في مصر، وكان موضوع الرسائل يدور حول المستقبل السياسي للأراضي العربية في الشرق الأوسط، حيث كانت المملكة المتحدة تسعى لإستثارة ثورة مسلحة ضد الحكم العثماني. تلا ذلك ما يسمى «الثورة العربية الكبرى» وهي ثورة مسلحة ضد الدولة العثمانية، بدأت في الحجاز، حينما أطلق الشريف حسين طلقه واحدة من بندقيته في الثاني من حزيران/يونيو 1916 في مكة المكرمة. هدفت الثورة، كما جاء في ميثاق دمشق، وفي مراسلات الحسين مكماهون التي استندت إلى الميثاق، على خلع طاعة الدولة العثمانية وإقامة دولة عربية، أو اتحاد دول عربية يشمل الجزيرة العربية ـ نجد و»الحجاز» على وجه الخصوص ـ وسوريا الكبرى ـ عدا ولاية أضنة التي اعتبرت ضمن سوريا في ميثاق دمشق ـ مع احترام «مصالح بريطانيا في جنوب العراق» ـ وهي المنطقة الجغرافية التي تبدأ في بغداد وتنتهي بالساحل الشمالي للخليج. وتبع ذلك صدور ما أصبح يسمى «وعد بلفور» وهو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
هذه التطورات الإقليمية المدفوعة بتدخلات دولية تواصلت خلال السنوات اللاحقة حتى وصلت آخر مرحلة من مراحل الدولة العثمانية التي انتهت بزوالها وتقسيم المناطق التي كانت تحت نفوذها. كان عام 1908 نقطة تحول جوهرية في عهد السلطان عبد الحميد وفي تاريخ الدولة العثمانية. وعرف عن هذا السلطان سعيه لترسيخ نظام الخلافة الإسلامية وأطلق شعار «يا مسلمي العالم اتحدوا». وكان عهده من أكثر أوقات الدولة العثمانية نجاحا وصعوبة في الوقت نفسه. وهكذا أسدل الستار على تاريخ طويل من الترابط العضوي بين الدول العربية والدول المجاورة على اساس الانتماء لدين الإسلام. وكان لعلماء الدين «الإصلاحيين» دورهم في توجيه الحراك الذي أثمر في 1907 بتشكيل أول برلمان منتخب. ولكن سرعان ما انقلب الشاه محمد علي القاجاري على تنفيذ ما مهد له، فقام في 23 حزيران/يونيو 1908، بإعلان حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية ثم تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشورى. ولكن تطورات أخرى مرتبطة بالسلطة العثمانية انعكست على الأوضاع الإيرانية. فقد قام الاتحاديون الأتراك بثورتهم الدستورية عام 1908، وأجبروا السلطان عبد الحميد الثاني في 23 تموز/يوليو من العام نفسه، على إعادة العمل بدستور 1876، وأطلق سراح جميع المعتقلين والمبعدين، وألغت الثورة الاتحادية الرقابة على الصحف، وتم تعيين وزارة جديدة حسب رغبة جمعية الاتحاد والترقي. وأجريت الانتخابات وفق الخطة. وفي أيلول/سبتمبر 1818 افتتح السلطان عبد الحميد البرلمان. تلك هي معالم تلك الحقبة برغم ما بها من صعوبات.
ما سمات الوضع الحاضر بعد مائة عام؟ الواضح أن الأوضاع لم تجمد على ما كانت عليه فحسب، بل ربما تراجعت إلى الوراء على صعدان شتى. فقد تداعت قيم التضامن والوحدة بين المسلمين، وعادت الهيمنة الأجنبية على المنطقة، واستبدلت قيم الإصلاح والتغيير والتطوير بتوجهات لا ترتبط بهذه الأهداف، بل تؤدي لعكسها. فالمائة عام التي تفصل بين الحقبتين زادت أوضاع الأمة تراجعا. فقد تم تنفيذ وعد بلفور عمليا، وفرض الكيان الإسرائيلي على العرب والمسلمين. واستبدلت سايكس بيكو السابقة بمناطق نفوذ جديدة بين أمريكا وروسيا. بينما أصبحت الدول العربية الكبرى مهددة بالتقسيم. فبعد السودان أصبحت سوريا والعراق ومصر أيضا تواجه هذا الخطر. ولا يستبعد أن تكون مخاضات الوضع السوري مقدمة لذلك التقسيم. قبل مائة عام كانت النخب المثقفة واعية ومتصدية للإصلاح. فقد جاءت تلك المرحلة بعد ظهور رجال عمالقة مثل السيد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده اللذين أطرا لمشروع الجامعة الإسلامية والاستقلال والتطور، وجاء بعدهم الإمام حسن البنا ليساهم في ذلك. وكان لعلماء كبار مثل السيد محمد كاظم الخراساني في إيران دوره في قيادة حركة الإصلاح الدستورية، وساهم علماء العراق كالسيد سعيد الحبوبي في مقاومة الانكليز، وقدم علماء مثل الشيخ محمد حسن النائيني أطروحات جديدة في مقولات الدولة الحديثة والتأصيل للفكر السياسي الإسلامي. تلك الحراكات الفكرية والسياسية تعبر عن وعي عربي إسلامي باتجاه الإصلاح ومقاومة الهيمنة الأجنبية والاستعمار والتصدي لمشاريع التقسيم والتجزئة. بينما تغيب عن الحقبة الحالية الشخصيات العملاقة القادرة على صياغة تاريخ جديد لدول المنطقة وشعوبها. مع ذلك تتواصل سياسات التقسيم والهيمنة بنمط لا يختلف كثيرا عما تضمنته خطط أعداء الأمة، كالتمرد على الدولة العثمانية باسم «الثورة العربية الكبرى» أو «وعد بلفور» أو سايكس بيكو. وهكذا يبدو التاريخ متوقفا عن الحركة بالاتجاه الايجابي، خصوصا في غياب الشخصيات التاريخية التي حظيت بها الحقبة السابقة. فهل تستطيع الأمة إعادة إنتاج العقول المستنيرة والضمائر الحية أم تبقى أسيرة للجهل والتخلف وتواصل حالة الموت السريري؟
جريدة القدس العربي
أضيف بتاريخ :2017/01/11