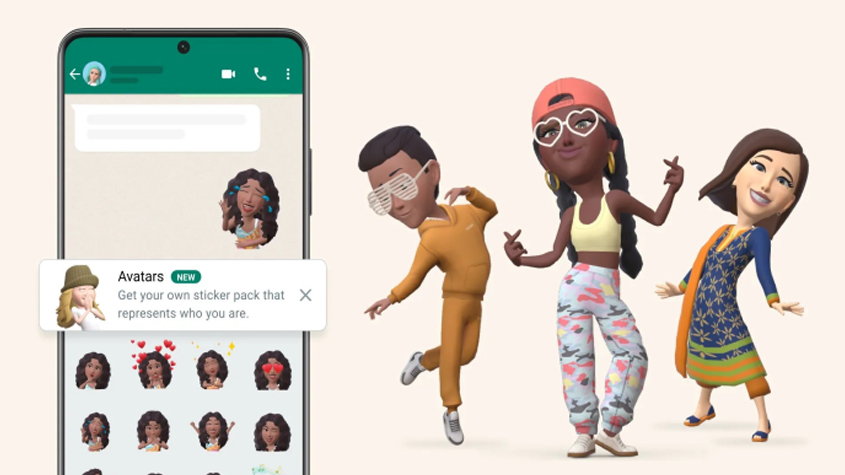أكتوبر، 2017: بين نقد الرأسمالية واستبدالها

عامر محسن
أن تنقد الرأسمالية لا يعني أن تجترح «بديلاً» لها، بل هو يفرض ــــ قبل أيّ شيء ــــ أن تفهم الرأسماليّة «كما هي»، أو بتحديدٍ أكثر (لأن هناك إمكانيّات مختلفة للتنظير للرأسمالية وتعريفها وتأريخها) أن لا تفهمها على نحوٍ «خاطىء» وأسطوريّ، أي على أنّها نظامٌ «طبيعيٌّ» منزل، أو تطوّرٌ حصل بشكلٍ «عضوي» يماشي الفطرة البشريّة، أو أنّ هناك شيئاً متعالياً اسمه «السّوق»، حياديٌّ وله منطقه الحسابيّ الخاصّ، ومنفصلٌ عن السياسة والمجتمع.
بل إنّ المشكلة تبدأ حين تعتبر أنّ هناك (بالمعنى العمليّ الواقعي، لا في النّظرية والفلسفة) كلّاً واحداً متشابهاً ومثالياً اسمه «الرأسماليّة»، تكون معه أو ضدّه؛ وأنّ هناك خياراً، كالباب الدّوّار، بين أن تخرج منه وتدخل إليه. كلّ الأنظمة الاقتصادية في القرن العشرين، بما فيها الاتحاد السوفياتي والصّين، يمكن النّظر إليها كاقتصاديّات رأسماليّة في الجوهر، وإن اختلف نمط الملكية فيها وتوزّع الدّخل، وهي عملت بحسب القواعد السوقيّة وأنماط التشغيل ذاتها التي تحكم أيّ اقتصادٍ صناعيّ. في الوقت نفسه، فإنّ الرأسماليّات على المستوى الوطني لا تتشابه حتّى ننظر إلى الرأسماليّة كنظامٍ واحد ونُطلق الأحكام بالتعميم. الرأسمالية في أميركا تختلف عن الرأسمالية في السّويد (حيث تتحكّم الدّولة بأكثر من نصف الدخل الوطني)، لأنّها تشكّلت في ظروفٍ تاريخيّة مختلفة ولها أدوارٌ مختلفة على الصعيد العالمي، وقد أنتج التفاوض بين العمّال ورأس المال فيها طريقاً تاريخياً خاصّاً لكلّ بلد.
هنا بيت القصيد، وهو فهم الطبيعة التاريخيّة والعارضة للنّظام الراسمالي الذي تعيش في كنفه (وإن لم تتّفق مع ماركس أو فيبر أو غيرهما على خصائصه البنيويّة)، وأنّ النّظام الاقتصادي\ السياسي الذي يحكمك ــــ بشكله الحالي ــــ ليس ضروريّاً ولا طبيعيّاً ولا محتّماً، ولا هو «وصفة» واحدة معروفة لها مفاعيل متشابهة في كلّ مكان. حين تفهم الرأسمالية كتكوينٍ تاريخيّ، وتفكّكك مؤسساتها ــــ على المستوى العالمي وفي بلدك ــــ وتكشف كيف ولماذا أصبحت موجودة، هنا يبدأ «الخيار» الفعلي، قبل أن نصل إلى «البديل». حين نرى النظام من حولنا كنتيجةٍ لمصالح ومسارات وصراعات سياسيّة، يصبح قبوله كما هو والدّفاع عنه خياراً، وأن نعدّله ونغيّره خياراً، وأن تقترح نظاماً مختلفاً بشكلٍ جذريّ هو أيضاً خيار. بمعنى أوسع، السؤال ديمقراطيٌّ في العمق: هل يكون بناء هذه المؤسسات («الرأسمالية») وتقرير نمط المعاش في يد طبقاتٍ شعبيّة وأكثريّة، تمثّل مصالحها وإرادتها، أم يبقى في يد القوى المحلية والدوليّة التي حدّدت هذه الخيارات عنك وأهدتك «رأسماليتك المحليّة«. وهناك، أيضاً، خيارٌ في أن نتجاهل الموضوع بالكامل ونتركه للخبراء، ونعتبر أن الرأسماليّة هي «حزمة» تأخذها أو ترفضها، أو «قدرٌ»، لا طائل من نقده والشكوى منه (الطّريف أنّه ما زال هناك من يردّ على من ينتقد الرأسماليّة بأن يقدّم «نظاماً بديلاً» أو يصمت، كأنّك تحتاج لأن تكون هيغل حتّى تفهم أنّك بائس. هذه المعادلات الثنائيّة، على طريقة كليشيه «الديمقراطيّة أسوأ الأنظمة باستثناء كلّ الباقين»، هي من النّوع الذي لا يعلّمنا شيئاً، بل يهدف فحسب إلى تشريع الموجود عبر التّظاهر بنقده).
«اصطناع الرأسمالية»
المفهوم المثالي و«الصّافي» عن الرأسماليّة والسّوق، الذي تمتدّ جذوره من بنتهام وريكاردو وصولاً إلى الاقتصاديين النيوليبراليّين المعاصرين، من السّهل نقده من النّاحية النظرية والتاريخيّة، لكن هذا لا يؤثّر على هيمنته على النّخب والمؤسسات الحاكمة في العالم. حتّى المؤيّدون «الأصوليون» لفريدريك فون هايك ــ المنظّر الأشهر لحريّة السّوق ــ يعتبرون أنّ النّسخة النيوليبرالية السائدة اليوم عن الاقتصاد سطحيّة، اختزاليّة، وأنّ النّظرة إلى السّوق كوعاءٍ فارغ أو كمحض أداة ليست وفيّةً لأفكار فون هايك (هايك كان يعتبر أنّ الحريّة الاقتصاديّة ضروريّة تحديداً لأنّ السّوق مندمجٌ في المجتمع، وليس فضاءً منعزلاً، وهو يشكّل عقدة النشاط الإنساني، فلا يجب أن يُترك لتنظيم الدّولة وعسفها). أصوليّو المدرسة النمساويّة يعتبرون أيضاً أنّ الأسواق «الحرّة» القائمة في الغرب اليوم لا علاقة لها بمثال فون هايك عن الحريّة، بل هي مؤسسات تتدخّل الدّولة فيها بشكلٍ كبير، كما رأينا خلال الأزمة المالية الأخيرة، وتوجّهها السياسات العليا والمصارف المركزية (أنظر، مثالاً، دراسة أندريا ميغون في The Review of Austrian Economics, عدد 24، سنة 2011).
الفكرة هنا لا تقتصر على المعادلة الشهيرة التي أرساها الباحث دوغلاس نورث، حين درس المؤسسات الاقتصادية فاستخلص أن «الأسواق الأكثر حرّيّة هي تلك الأكثر تنظيماً وقوننة». المعنى هنا هو أنّ ما يجعل السّوق «حرّاً» ومفتوحاً في بلدٍ مثل أميركا، وفي وسعك أن تفتح حساباً في دقائق، أو تشتري وتبيع بسهولةٍ واطمئنان، والمعاملات التجارية والعقود تجري بسلاسة ويسر، ما يسمح بكلّ ذلك هو شبكة كثيفة من المؤسسات والقوانين والأجهزة الرقابية، بُنيت وتراكمت على مدى عقود، وتسمح بإدارة هذه اللعبة وضمانها، وتقرير بروتوكولات التبادل، وتردع المخالفين، الخ… وهذه الخلاصة لها أكثر من انعكاسٍ على تخطيط السياسات والاقتصاد، فهي تعني، من ناحية، أنّه لا يمكن لأيّ بلدٍ فقير لا يملك سوقاً وطنيّة منظّمة أن يحصل على «سوقٍ حرّ» بمجرّد ترك الأمور على غاربها، و ــــ من ناحيةٍ أخرى ــــ أنّه لا يكفي أن تلغي التنظيمات والقوانين الموجودة وتشطبها ــــ على طريقة «علاج الصّدمة» ــــ حتى تنبثق، بشكلٍ عضويّ وتلقائي، آليات سوقٍ حرٍّ وتنافسيّ تستبدلها (وهو ما اكتشفته، بكلفةٍ هائلة، دول أوروبا الشرقية وبلاد الجنوب التي اندفعت في مشاريع «تحرير» الاقتصاد).
المسألة أعمق من ذلك، وقد عبّر عنها المفكّر كارل بولاني حين تابع نشوء الرأسمالية في بلدٍ كبريطانيا على مدى قرون، ووجد أنّ مشكلة النظرية الليبرالية لا تقتصر على طريقة ادارتها لـ«السّوق»، بل في أنّ منطقها السوقي، الحسابيّ، يتسلّل الى كلّ مناحي الحياة والمجتمع. أمورٌ مثل الأرض والعملة والعمل، يكتب بولاني، لم تكن تاريخياً «سلعاً»، تخضع لحسابات العرض والطّلب والربح والخسارة، بل كانت دوماً مؤسّسات «مندمجة» في المجتمع، الذي يحدّد ملكيّتها وحصانتها وكيفية التصرّف بها؛ فتحوّلت هذه العناصر، التي كانت أساسيّة في تعريف الحياة والفرد، إلى سلعٍ منسلخةٍ عن المجتمع، تُعامل كالمنتوجات التي يصنعها الإنسان ويبيعها في السّوق. المنطق الاقتصادوي هذا يتوسّع مع كلّ موجةٍ ليبرالية جديدة إلى أركانٍ جديدةٍ في الحياة، فيتمّ تعديل نظام ترقية الباحثين في بريطانيا والعديد من دول الغرب، مثلاً، ليطابق قواعد «سوقية» وتنافسية، وتحاول الحكومة الأميركية «إصلاح» نظامها التعليمي عبر إدخال آليات السّوقٍ إليه. ويقرّر معيار الرّبح والخسارة ورغبة القطاع الخاص، في عصر انحسار الملكية العامّة، ما إن كان مشروعٌ ما يستحقّ أن يُبنى أو لا يستحقّ. في هذا السّياق النيوليبرالي، من الطبيعي أن تصبح العلاقات الإنسانية أيضاً، ومعايير الاحترام والحبّ والزّواج، مرتبطةً بالمنطق الحسابيّ ذاته. تسليع أسس المجتمع، يقول بولاني، وإخضاعها لمنطقٍ حسابيّ نظريٍّ مثاليّ، يدمّر، لو استبدّ، التراث والدّين والأخلاق وكلّ ما يربط النّاس ببيئتهم. المفارقة هنا هي أنّ العديد من المثقّفين ينظرون إلى أيّ مشروعٍ اشتراكيّ (سابقٍ أو حاليّ أو افتراضي) يتحدّى الشكل القائم للرأسمالية على أنّه مشروعٌ نظريّ، مثاليّ، يخالف الطبيعة ويبغي إعادة تشكيلها؛ ولكنّهم يعتبرون في الوقت ذاته أن الرأسماليّة الليبراليّة (التي تمثّل تطبيقاتٍ لـ«نموذج» مثاليّ وضعته نخبٌ غربيّة، وهي تهندس الاجتماع البشريّ منذ أكثر من قرنين ليتوافق المجتمع مع نظريّتها)، هي أمرٌ «طبيعيّ» لا يستدعي المساءلة أو التعديل ــــ وهنا، تحديداً، المعنى الأعمق للهيمنة.
البديل القادم
اشتراكيّة المستقبل، أو «البديل الجديد»، لن يُبنى وفق مخطّطٍ معدٍّ سلفاً، ولن يكون تكراراً لتجارب الماضي. إنّ أسوأ أمثولةٍ يمكن استخلاصها من ثورة أكتوبر، ومن التجربة السوفياتيّة، هو أن تعتمدها كـ«خارطة طريقٍ» للنظام الذي سيتحدّى الهيمنة الليبراليّة في المستقبل، وهذا يعود لسببين. أوّلاً، لأنّ التجربة السوفياتيّة وشكل الاشتراكية فيها كانا نتاج سياقٍ تاريخي وجغرافي خاصّ، لن يتكرّر كما هو. يُجمع المؤرّخون، مثلاً، على أنّ لينين وستالين، لو كان لهما الخيار وكانت روسيا معزولة بالكامل عن النظام العالمي، لاختارا طريقاً مختلفاً إلى الاشتراكيّة بعد الثورة: كان البلاشفة يفضّلون ــــ في ظروفٍ مثاليّة ــــ انتقالاً أكثر بطئاً وسلاسة، من دون الحاجة إلى التصادم مع المزارعين أو حشد المجتمع للتصنيع والنموّ بشكلٍ محموم. وكانت روسيا السوفياتية ستتبع، على الأرجح، نمط تنمية ريفيّ و«شبه برجوازي»، مع انتخاباتٍ تستوعب تيارات مختلفة، والغاءٍ تدريجي ومدروس للملكية الخاصّة. ولكنّ الشيوعيين الأوائل وجدوا أنفسهم في بلدٍ ريفيّ طرفيّ، تحاصره الدول الكبرى بالعداء، ويتوقّع حرباً (جديدةً) عليه خلال عقدٍ أو أقلّ، فلا مناص من التّصنيع الثقيل وإدارة الدّولة للإنتاج حتّى تصبح ندّاً للقوة الأوروبيّة ــــ وحلّ «المسألة الزراعية» بأسرع ما يمكن، ولو بالعنف و«التّجميع» (وقد حدّدت هذه الخيارات، للعقود القادمة، شكل الدّولة السوفياتية ونقاط قوتها وضعفها).
من جهةٍ أخرى، فإنّ البلاشفة أنفسهم لم يكونوا يملكون خطّةٍ اقتصاديّة «اشتراكية» متّفق عليها وقد رسمها لهم ماركس. المجتمع الشيوعي هو فكرة «نهائية» مثاليّة، لا يوجد توافق حول الطّريق إليه أو حتّى على شكله ــــ حين يتحقّق ــــ بالمعنى العمليّ. كما أنّ مشكلة تحويل «السّعي إلى الاشتراكية» إلى برنامج وسياسات لم يواجهها أحدٌ في أوروبا بشكلٍ جدّيّ حتّى وصل السّوفيات إلى الحكم. لهذه الأسباب، كان لينين وستالين يرتجلان بحسب السّياق، ويقرّان سياسات «تجريبيّة» لم يعرفها التاريخ من قبل. من جهةٍ أخرى، لم ينظر الزعيمان السوفياتيان إلى الماضي بحثاً عن سوابق لإتّباعها، بل آمنا بشكلٍ كبيرٍ بقدرة الحداثة والجديد، والتكنولوجيا والتنظيم، على تذليل العوائق المادّيّة. حين بنى ستالين مصاهر الفولاذ في ماغنيتوفورسك، في قلب الأورال، فهو اختار أحدث التصاميم في العالم وأضخمها، كما يوثّق ستيفن كوتكِن في كتابه عن المشروع، وصمّم مدناً كاملة على أسسٍ «عقلانيّة» و«علميّة»، كانت تمثّل آخر صيحةٍ في عصره. اعتنقت المؤسسات الصناعيّة أيّام ستالين أحدث وسائل التّنظيم، وكانت الصّحف والمجلّات (سواء المتخصّصة منها أو الموجّهة إلى العمّال) تناقش بشكلٍ مستمرّ النظريات التايلورية والفوردية التي تخرج في الغرب، وتقنيّات زيادة الإنتاجية على خطوط التصنيع. وقد نشأت حينها، بحسب كوتكِن، «مذاهب» ومدارس متعدّدة، على طريقة برامج «التنمية البشرية» اليوم، تزعم أنّها طوّرت سبلاً جديدة لرفع فعاليّة العامل وتثوير إنتاج المصنع، وتمزج، مثلاً، التايلورية بالفلسفة وباليوغا.
لو أردنا إسقاط هذه التجربة على الواقع الحالي والتفكير في «اشتراكية المستقبل»، فهذا لا يعني أن نستنسخ التجربة الحمراء وأحزابها، ومعامل الفولاذ وتي ــــ 55، بل هي تشبه ــــ في سياق اليوم ــــ أن نستخدم التقنيات الحديثة في التنظيم وربط النّاس، وأن نستفيد من العولمة وهامشها، وأن تكون هناك نقاشاتٌ مستمرّة حامية بين الناشطين العرب حول قضايا مثل الطّاقة الشمسيّة وتنظيم الاقتصاد والمسألة الزراعيّة؛ وعن الاحتمالات الجديدة للإدارة والحياة التي تفتحها التكنولوجيا الجديدة، الخ… الأساس هو أنّك تتعلّم من الماضي ولا تكرّره، ولا أحد يعرف متى تكون «اللحظة الثورية» ومتى يخرج «النّظام البديل»، ولا كبير فائدة من الانشغال في تصميمه مسبقاً؛ وأنت ــــ كما في الماضي ــــ لن تحتاج إلى تصميم «نظامٍ بديلٍ» حتّى تقتنع النّاس بضرورة الخروج على النّظام القائم، فالرأسماليّة المهيمنة ستقوم بهذه المهمّة عنك. ولكنّ السؤال الابتدائي، الذي يجعل كلّ هذه الاحتمالات ممكنة، هو نظرتك إلى الحياة والى الأمل؛ وهل أنت تعتبر نظام العالم ناقصاً وظالماً، وهو قابلٌ دوماً للتحسين، أم أنّك لا تراه إلّا ميداناً للصراع والغلبة، أو سلّماً تتسلّق عليه؟ وقبل ذلك كلّه، هل أنت مؤمنٌ بأنّ قدرك وعالمك هو في يدك، أنت تقدر على تشكيله بالإرادة والعمل، أم أنّك تترك تقرير هذه المسائل لغيرك وتنهمك في ما هو «أهمّ» ــــ كالصراع بين الطوائف؟
صحيفة الأخبار اللبنانية
أضيف بتاريخ :2017/10/25